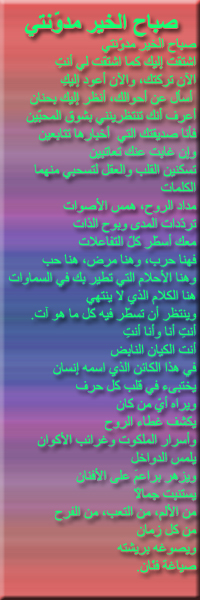من البديهيات التاريخية أن الكيان الصهيوني الغاصب قائم في أصله وأساسه على السطو، واحتلال أراضي الغير، وهو الكيان الذي تجمّع شتات اليهود فيه من جميع أصقاع العالم على أرض ليست لهم، بل اغتصبوها من أجل ذلك.
كل هذه البديهيات تؤكّد أنّ "دولة اسرائيل" التي زرعت على أرض ليست لها، لا ماضي لها ولا تراث، وأن سكانها من اليهود هم مجموعة من البشر ارتضوا لأنفسهم أن يكون لهم دولة على أرض اغتصبوها من أهلها معتمدين في ذلك سياسة القتل والتدمير والتهجير.
بقوة الإرهاب قام هذا الكيان الغاصب واستمر، وبدعم دولي غير مسبوق أخذ شرعية الدولة المسماة إسرائيل.
ولما كان "الشعب" في اسرائيل مكوناً من مجموعة أشخاص ينتمون إلى عرقيات وإثنيات مختلفة، لم يستطيعوا تكوين أي تراث يخص هذه الدولة المصطنعة، وكان لا بدّ من ايجاد هذا التراث، ولو على الطريقة التي قامت بها دولة اسرائيل، وهي طريقة السطو والنهب والسرقة من كل الدول المجاورة.
فالتراث هو الذي يشير إلى حضارة كل بلد، من ثقافة وفن وزي وفلكلور ومأكولات شعبية، فيحفظها على أنها تخص هذا البلد دون ذاك، فنرى أن كل بلد من البلدان يشتهر بخصائص تميّزه عن غيره.
وكان لا بد لـ"إسرائيل" من التعدي على تراث الآخرين، لتنسب ما تشتهيه لنفسها على أنه تراثها، على حساب تدمير تراث الآخرين وتشويه صورتهم.
وطبعاً كان للبنان نصيب الأسد من هذه التعديات، لبنان الذي تطمع إسرائيل في كل خيراته، في أرضه ومياهه، امتدّت يدها أيضاً إلى تراثه، لتسرق أهم ما يميز المطبخ اللبناني، وهي المازة اللبنانية ـ الحمص والفلافل والبابا غنوج والكبة (أقراص الكبة المقلية) والتبولة والفتوش ـ وتصنّعها وفقاً للطريقة اللبنانية الذي اشتهر بها المطبخ اللبناني منذ مئات السنين، ومن ثم تقدمها على أنها مأكولات من التراث الإسرائيلي، وعلى أنها صناعات غذائية اسرائيلية الأصل والصنع.
هذا الأمر يحدث منذ سنوات عديدة، فقد أكد أحد المغتربين اللبنانيين في كندا، أن هذه المعلبات التي تحتوي على هذه المأكولات اللبنانية الجاهزة تباع منذ أكثر من 13 سنة على أنها إسرائيلية.
كما أن إسرائيل تصدّر منذ سنوات الحمص الى بريطانيا، وتدّعي انه طبق تقليدي للشعب الاسرائيلي.
وتحتدم المعركة اليوم بعد تحرك جمعية الصناعيين اللبنانيين لتقديم دعوى ضد اسرائيل بسبب هذه السرقات، ولا سيما أنها تتسبّب بخسارة عشرات ملايين الدولارات سنوياً بحسب فادي عبود رئيس الجمعية، حيث تقوم "اسرائيل" بتصنيع هذه المأكولات وتقديمها في علب صغيرة بلاستيكية للمستهلك في المحلات والسوبرماركات في أوروبا والولايات المتحدة، على أنها مأكولات تقليدية إسرائيلية، بينما هي في أصلها وتركيبتها وأسمائها لبنانية.
كما يؤكّد فادي عبود أن الخسارة ليست مادية فقط، وإنما هي خسارة معنوية كبيرة، فـ"إسرائيل" تسرق حضارتنا، وهويتنا الثقافية، وموسيقانا واليوم مطبخنا. فوجئنا في معارض عدة برؤية الكشك والكبة والتبولة ودبس الرمان والحمص، والحمص بطحينة وماء الورد وماء الزهر ومئات الأصناف، مصنّعة في "اسرائيل" مع الادعاء انها أصناف اسرائيلية.
واعتبر أننا لا نستطيع منع "إسرائيل" من تحضير اصنافنا، ولكن على الأقل يجب الا نسمح لها بأن تسرق مطبخنا وتدّعي انه لها.
وحتى تتمكّن الجمعية من إقامة هذه الدعوى لا بد لها من إثبات تاريخ انتماء هذه المأكولات إلى لبنان وتسجيلها لتقديمها الى المحكمة الاوروبية، بما ان لبنان موقّع اتفاق شراكة مع أوروبا، إذ أن الدول الأوروبية بدأت بتسجيل أصنافها ومنتجاتها الزراعية والجغرافية منذ العام 1992، ولبنان لم يقم بتسجيل أي من منتجاته عالمياً بعد، لكنه يمكن أن يفعل ذلك الآن من خلال العمل على إعداد ملف كامل عن هذه المنتجات بمساعدة وزارة الاقتصاد والتجارة، ومن خلال الأبحاث التاريخية الموجودة حول هذه المنتجات، واذا ما اكتمل الملف يمكن تسجيل هذه المنتجات خلال 6 أشهر وسنة ونصف السنة، إذ يبقى ذلك رهن اكتمال عناصر الملف.
ويشير هنا فادي عبود إلى أنه "ليس بالضرورة ان تقتنع فورا الجهات الاوروبية المعنية، بل سيجري الأوروبيون تحرياً واسعاً للتأكد من أنّ هذه الاصناف لبنانية".
ويرتكز تفاؤل جمعية الصناعيين اللبنانيين في نجاح عملية التسجيل على سابقة حدثت اليوم، عندما حصل صراع حول الجبنة اليونانية "فيتا" وكسبت اليونان الدعوى، ولذلك يستطيع لبنان اعتماد الأسلوب نفسه الذي اعتمدته اليونان، وهو أن هذه المواد الغذائية معروفة تاريخيا وتقليديا على أنها مأكولات شعبية لبنانية".
كما استطاع لبنان سابقاً أن يثبت أن الحمص والكبة والصفيحة، اصناف وصلت الى البرازيل في عام 1862 مع هجرة اللبنانيين. واول علبة حمص بالطحينة، صنّعت في الشرق الاوسط، خرجت من لبنان، وكان ذلك في خمسينات القرن الفائت، بناء على أبحاث تعود إلى 200 و300 سنة.
لبنان الذي استطاع تحرير معظم أراضيه، واستطاع تحرير مياهه وأسراه، سيستطيع ان شاء الله تعالى تحرير كامل تراثه من براثن العدو الصهيوني الذي لا يكف عن الاعتداء، فلا بدّ لكل مقاومة تسلك طريق الحق من الانتصار.
ماجدة ريا