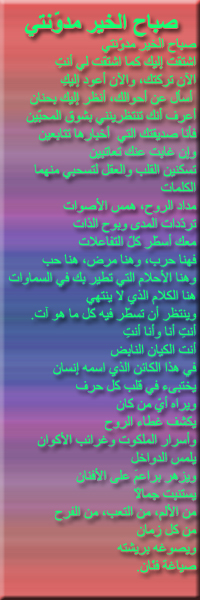ربما نشعر أن المجتمع بدأ يتحرّك نحو الأفضل، وأن كثيراً من الناس يسعون إلى تحسين أوضاعهم، وأوضاع عائلاتهم.
وربما نعتقد أن المجتمع آخذ بتحسين نظرته نحو الأنثى بشكل مطّرد بسبب تحرّكها الفاعل أو بسبب الثقافة المنتشرة أو ما إلى ذلك.
ربما الوعي الديني الذي يعطي الأنثى حقوقها كاملة في الإسلام ويعاملها على أنها متساوية في الإنسانية مع الذكر له دوره الأكثر فعالية في تحسّن الكثير من الأمور التي كانت تُمارس باسم الدين وهي ليست سوى أعراف قبلية، ومخلّفات جاهلية رزحت تحتها المرأة ردحاً طويلاً من الزمن، ولا زالت بعض آثارها تنتشر هنا وهناك، لأن المجتمعات العربية لا زالت في قسم كبير منها تعاني الجهل. ويصبح الجهل أكثر قتامة عندما يدّعي البعض العلم وفي داخله يبقى جاهلاً لأبسط حقائق الأمور.
جاء الإسلام ليغيّر عادة وأد البنات، بل ليجعل من الأنثى رحمة، وبشارة لأهلها، بعد أن كان يسودّ وجه من يُبشّر بها، وربما لا زال هناك أشخاص حتى يومنا هذا تسودّ وجوههم عندما يبشّرون بالأنثى، ويعتبرونها هماً وغماً، وحملاً قد يجلب العار! ولكن قد لا يجرأون على وأدها، بل يعاملونها بكثير من التشدّد والصرامة، التي قد تجعلها تعيش حالة الوأد تلك كل يوم، وأحياناً يتجاوز الأمر كل الحدود.
ونفاجأ ونحن في القرن الواحد والعشرين بعائلة تخاف على ابنتها إلى الحد الذي يضطّر معه رب الأسرة إلى تركها عند أهل الأب أثناء انتقالهم إلى العيش في بلد غربي "خوفاً عليها من التلوّث بالقيم الغربية والحياة الغربية"، بينما يذهب باقي أفراد العائلة إلى هناك ـ الأب، الأم، الأخوة الذكور ـ وتبقى الفتاة المسكينة منذ صغرها في عهدة جدّيها وعمّها العازب والذي لا يملك أي خبرة تربوية ليتسلّط عليها كيفما يشاء!.
فهل حموها بذلك؟ وأي ضغط نفسي تعيشه مثل هذه الفتاة التي تحرم من العيش في أحضان عائلتها لمثل هذا السبب الذي قد يصبح سخيفاً جداً أمام ما يتهدد حياتها.
أليس من الأفضل أن يصطحبوها معهم ويحافظوا عليها كما يحافظون على أنفسهم؟
كثيرة هي العائلات التي استطاعت أن تربّي أبناءها في الغرب تربية صالحة، وتجعلهم يحافظوا على دينهم وأخلاقهم، وأن يكونوا قدوة يحتذى بها هناك!
ولكن ... ما أسهل على البعض التنصّل من مسؤولياته، ليقول لا أستطيع، وأخاف، بينما هو بذلك يزيد المشكلة تعقيداً، ويزيد من مخاطر السوء الناجمة عن تصرفه، وعلى اعتبار أنه لا يحق للأنثى ما يحق للذكر، بينما هما متساويان في حق البنوة والتربية والعيش السليم، من أجل بناء نفسية سليمة، ومجتمع سليم.
.ماجدة ريا
وربما نعتقد أن المجتمع آخذ بتحسين نظرته نحو الأنثى بشكل مطّرد بسبب تحرّكها الفاعل أو بسبب الثقافة المنتشرة أو ما إلى ذلك.
ربما الوعي الديني الذي يعطي الأنثى حقوقها كاملة في الإسلام ويعاملها على أنها متساوية في الإنسانية مع الذكر له دوره الأكثر فعالية في تحسّن الكثير من الأمور التي كانت تُمارس باسم الدين وهي ليست سوى أعراف قبلية، ومخلّفات جاهلية رزحت تحتها المرأة ردحاً طويلاً من الزمن، ولا زالت بعض آثارها تنتشر هنا وهناك، لأن المجتمعات العربية لا زالت في قسم كبير منها تعاني الجهل. ويصبح الجهل أكثر قتامة عندما يدّعي البعض العلم وفي داخله يبقى جاهلاً لأبسط حقائق الأمور.
جاء الإسلام ليغيّر عادة وأد البنات، بل ليجعل من الأنثى رحمة، وبشارة لأهلها، بعد أن كان يسودّ وجه من يُبشّر بها، وربما لا زال هناك أشخاص حتى يومنا هذا تسودّ وجوههم عندما يبشّرون بالأنثى، ويعتبرونها هماً وغماً، وحملاً قد يجلب العار! ولكن قد لا يجرأون على وأدها، بل يعاملونها بكثير من التشدّد والصرامة، التي قد تجعلها تعيش حالة الوأد تلك كل يوم، وأحياناً يتجاوز الأمر كل الحدود.
ونفاجأ ونحن في القرن الواحد والعشرين بعائلة تخاف على ابنتها إلى الحد الذي يضطّر معه رب الأسرة إلى تركها عند أهل الأب أثناء انتقالهم إلى العيش في بلد غربي "خوفاً عليها من التلوّث بالقيم الغربية والحياة الغربية"، بينما يذهب باقي أفراد العائلة إلى هناك ـ الأب، الأم، الأخوة الذكور ـ وتبقى الفتاة المسكينة منذ صغرها في عهدة جدّيها وعمّها العازب والذي لا يملك أي خبرة تربوية ليتسلّط عليها كيفما يشاء!.
فهل حموها بذلك؟ وأي ضغط نفسي تعيشه مثل هذه الفتاة التي تحرم من العيش في أحضان عائلتها لمثل هذا السبب الذي قد يصبح سخيفاً جداً أمام ما يتهدد حياتها.
أليس من الأفضل أن يصطحبوها معهم ويحافظوا عليها كما يحافظون على أنفسهم؟
كثيرة هي العائلات التي استطاعت أن تربّي أبناءها في الغرب تربية صالحة، وتجعلهم يحافظوا على دينهم وأخلاقهم، وأن يكونوا قدوة يحتذى بها هناك!
ولكن ... ما أسهل على البعض التنصّل من مسؤولياته، ليقول لا أستطيع، وأخاف، بينما هو بذلك يزيد المشكلة تعقيداً، ويزيد من مخاطر السوء الناجمة عن تصرفه، وعلى اعتبار أنه لا يحق للأنثى ما يحق للذكر، بينما هما متساويان في حق البنوة والتربية والعيش السليم، من أجل بناء نفسية سليمة، ومجتمع سليم.
.ماجدة ريا